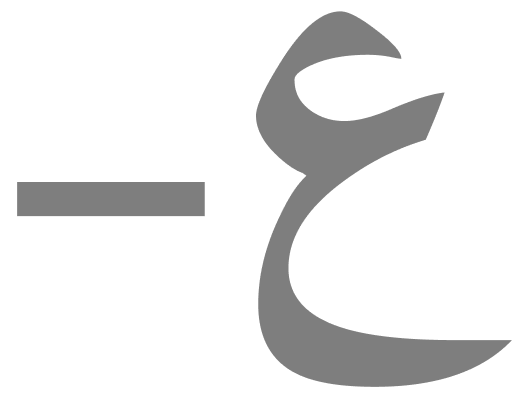القراءة وإنتاج المعرفة
أضحى مجتمع المعرفة والشراكة الفاعلة في تشكيله مبدأ حاكماً لعالم اليوم. بل إننا نذهب إلى أن هذا المبدأ بات يحكم فاعلية واستمرار المجتمعات البشرية على قيد الوجود في زمن أصبحت المعرفة فيه موصولة بكافة مكونات النشاط الإنساني، وباتت القاطرة التي تقود مسيرة التحولات في عالم يشهد انفجاراً معرفياً غير مسبوق. لذا لم تعد المعرفة قرين الوجود الفاعل لمجتمعات عالم اليوم واستمرارها على قيد الحياة فقط، بل أضحت في الوقت نفسه، مصدراً من أهم مصادر القوة التي تحوزها هذه المجتمعات، حيث لم تعد قوة المجتمعات والدول تقاس بما تملك من قدرات اقتصادية، بل بما تملك من قدرات معرفية. فقد صارت «المعرفة قوة»، تضفي على حائزيها أفراداً ودولاً ومجتمعات -مزيداً من الفاعلية والتأثير، وقدرة أكبر على المنافسة، محلياً وعالمياً، وعلى مختلف الأصعدة الفكرية والحضارية والاجتماعية والسياسية.
وها نحن اليوم نرتاد فضاءً جديداً من الفضاءات اللامتناهية لعالم القراءة، نتأمل من خلاله طبيعة العلاقة بين القراءة وإنتاج المعرفة، وكيف تكون القراءة سبيلاً لاكتساب المعرفة، ونشرها، وإنتاجها على حد سواء.
فما المقصود بالمعرفة؟ وما طرق حيازتها وإنتاجها؟ وما دور القراءة في عملية حيازة المعرفة، ونشرها وإنتاجها؟ هذا ما نحاول الإجابة عليه في مقال اليوم.
إن المعرفة التي نقصدها في هذا السياق هي مجموع المعارف والمهارات التي يكتسبها الإنسان طوال مسيرة حياته، سواء من خلال التعلم أو من خلال التأمل أو التجربة. وما يترتب على ذلك من ارتقاء الإدراك الإنساني، والفهم الواعي لحقائق العالم الذي يعيش فيه الفرد.
ولاشك أن اكتساب المعرفة عملية مستمرة ذات طابع تراكمي. وهي أولى الخطوات التي تسهم في بناء المعمار المعرفي للفرد... وبقدر ما ينمو الفرد من الناحية العمرية أو الإدراكية بقدر ما تتعدد وتتنوع مصادر المعرفة التي تشكل هذا المعمار. إن المعرفة تساوي هنا رأس المال الفكري أو المعرفي الذي يكتسبه الفرد طوال مسيرة حياته المعرفية.
وتتنوع المصادر التي يكتسب الفرد من خلالها المعرفة، كما تنمو كلما نما الفرد من الناحية العمرية والمعرفية، ويأتي على رأس هذه المصادر: المؤسسات الثقافية والإعلامية ومؤسسات التعليم والبحث العلمي. وإذا كانت عملية اكتساب المعرفة وتراكمها ترتقي بالقدرات الفكرية للفرد وتزيد من رأس ماله الفكري، فإن قيمة رأس المال هذا لا تتحقق إلا من خلال قدرة الفرد على توظيفه بما يعود عليه بالنفع، ويعزز قدرته على التأثير في محيطه الاجتماعي. ويساهم -على المستوى المجتمعي- في تكوين رأس المال البشري القادر على المنافسة، والقادر على تحقيق الشراكة الفاعلة في مجتمع المعرفة. ومن ثم فإن اكتساب المعرفة، فضلاً عن استيعابها، وإنتاجها عملية موصولة الأبعاد. تتخذ طابعاً يمكن أن نسميه «دورة المعرفة». فلا يمكن للفرد -ولا المجتمع- أن يكون منتجاً للمعرفة دون أن يكتسبها ودون أن يكون حائزاً لها. ويستطيع أن يستوعبها، ويتمكن، في الوقت نفسه، من أن يوظفها ويستفيد منها في كل مناحي الحياة. وفي ذلك تؤكد العديد من الدراسات على أن مجتمع المعرفة هو ذلك المجتمع الذي يقوم أساساً على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات النشاط الفردي والمجتمعي.
ثمة تلازم إذن بين اكتساب المعرفة وإنتاجها والقدرة على نشرها وتوظيفها. وهي عملية متلازمة الأبعاد، يفضي أحدها إلى الآخر. فلا يصح أن تقف هذه العملية عند حدود اكتساب المعرفة فقط؛ وإلا تحول الفرد أو المجتمع إلى مستقبل سلبي أو مستهلك للمعرفة دون أن يشارك في إنتاجها.
كما لا ينبغي أن تتوقف هذه العملية عند حدود إنتاج المعرفة فقط، بل يجب توظيف هذه المعرفة بما يساهم في تنمية القدرات المعرفية للفرد والمجتمع. وإن عدم القدرة على توظيف المعرفة في كل مجالات الحياة يعني أن المعرفة التي تم اكتسابها تصبح عديمة الجدوى.
لكن ما دور عملية القراءة في اكتساب المعرفة وحيازتها وفي إنتاجها ونشرها والقدرة على توظيفها؟
يمكن القول إن العلاقة بين القراءة والمعرفة علاقة متلازمة، أو هي وجهان لعملة واحدة. فلا معرفة بدون قراءة ولا قراءة بدون معرفة. وبقدر ما يقرأ الفرد، بقدر ما تتسع مداركه، وتنمو قدراته المعرفية. بل إننا نذهب إلى القول إن القراءة تمثل وسيطاً فاعلاً يقع في القلب من عملية اكتساب المعرفة وإنتاجها ونشرها وتوظيفها. ولا يمكننا تخيل اكتمال دورة المعرفة دون أن تكون القراءة إحدى أهم المراحل التي لا تكتمل هذه الدورة بدونها. فإذا افترضنا جدلا أن اكتساب المعرفة يمثل الحلقة الأولى من حلقات دورة المعرفة، وأن إنتاجها ونشرها وتوظيفها يمثل المنتج النهائي لهذه الدورة، فإن القراءة هي الحلقة التي تقع في القلب من عملية اكتساب المعرفة وإنتاجها ونشرها والقدرة على توظيفها.
حيث تعد القراءة الوسيلة الأولى التي تمكن الفرد من اكتساب المعرفة. وهي الوسيلة الأساسية للارتقاء بالقدرات الوجدانية والمعرفية للفرد، وهي بذلك تساهم في تكوين وتنمية بنائه المعرفي. وتعد القراءة، من ناحية ثانية، الوسيلة الأساسية للاطلاع على تجارب الآخرين في كافة مجالات الفكر والإبداع. وهي التي تمكننا من فهم واستيعاب، والاستفادة من، المنجز المعرفي والثقافي للآخرين، سواء كان هؤلاء الآخرون شركاء في المجتمع الذي ننتمي إليه، أم شركاء في المجتمع العالمي.
وإذا كانت القراءة وسيلة أساسية لاكتساب المعرفة فإنها تعد، في الوقت نفسه، وسيلة أساسية لنشر هذه المعرفة. فلا يمكن أن يتم اكتساب المعرفة، فضلاً عن نشرها في مجتمع ترتفع فيه نسبة الأمية، سواء بمعناها الأبجدي (عدم معرفة القراءة والكتابة) أم بمعناها الثقافي والمعرفي (عدم القدرة على التعامل بكفاءة مع منجزات عصر التكنولوجيا وثورة المعلومات). وفي ذلك يؤكد العديد من الدراسات على أن الأمية تشكل معوقاً من أهم المعوقات التي تؤدي إلى نقص القدرات الإنسانية اللازمة لاكتساب المعرفة. وهذا ما يفسر لنا عمق الفجوة المعرفية أو الفجوة الرقمية بين الدول والمجتمعات التي تحوز المعرفة وتتمكن من إنتاجها وتوظيفها، وتلك المجتمعات التي باتت مهددة بالخروج من حلبة المعرفة نتيجة لارتفاع معدلات الأمية وما يترتب على ذلك من نقص القدرات المعرفية اللازمة لتحقيق الشراكة الفاعلة من أجل المعرفة. ويستحيل في تصوري تحقيق هذه الشراكة من دون إن تكون القراءة هي سبيلنا ليس فقط لتحقيق التلازم بين اكتساب المعرفة ونشرها وتوظيفها، بل من أجل أن تكون القراءة هي الدائرة التي يجتمع عند مركزها رأس المال المعرفي ورأس المال الثقافي لتهب الشراكة من أجل المعرفة آفاقاً متجددة تتسع لآفاق المعرفة نفسها التي لا تكف عن التغير والتجدد في كل وقت وفي كل حين.